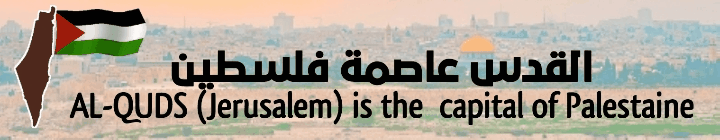سلطان الفقراء (1)
(عيدروس محمد الحبشي في كتابه بدوي زبير فنانًا وإنسانًا) ... أو (سلطان الفقراء)
سلطان الفقراء لقب أطلقه أنيس وصديق وعاشق أهل الغناء والطرب والموسيقى (عيدروس محمد الحبشي على المطرب المُنفق في الخفاء بسخاء على الفقراء (أحمد يسلم زبير) في كتابه المعنون ب (بدوي زبير فناناً وإنساناً) تعمد فيه تقديم صفة الفنية على الصفة الإنسانية، وربما مسوغه أن أغلبية الناس يعرفون بدوي الفنان، وثلة يعرفون بدوي الإنسان بخاصة من لازموه وعاشروه في حياته، ومن أطلعهم على أسرارِه ووكلهم بمهمات.
تيسير من نوى بإخلاص أن ينفق عليهم، وبمناسبة ذكر العنوان الرئيس الذي استقر على تقديم صفة الفنية على الإنسانية فإنه لم يستند إلى معيار التوازن في صفحات الكتاب بين الفني والإنساني، بل استند في غالب الظن إلى فكرة بدوي الفنان رغم انشغاله بالمظاهر الإنسانية أكثر من الفنية. والمقال لن يشغل نفسه بمسألة تقديم هذه الصفة على تلك، أو تلك على هذه لأن ما لفته واستهواه هو عبارة (بدوي سلطان الفقراء) الدالة على الكرم النظيف من الرياء
والجفاء، والضجيج والضوضاء ، ووجد في مثل هذه العبارة لمعانا يسطع بالرحمة والود والمحبة للناس الذين نالت منهم الفاقة وألحت عليهم الحاجة ، وصفة السلطانية لا تعني الهيمنة عليهم وإذلالهم مثلما يفعل سلاطين الدول، بل سلطان الرحمة وقوتها التي ترفع الخشونة عن حياتهم وتمنحها شيئًا من النعومة ومعروف أن السلطان السياسي يبحث عن القوة والنفوذ لقهر الآخرين بل يقتلهم إذ تطلب الأمر بحسب منطق القوة لا قوة المنطق، أما السلطان بدوى زبير فيسعى لتصنيع قوة الرحمة ليدخل الفرح في قلوب الفقراء ولا يتردد ابدًا من أن يحملهم على بساط فنه ليطير بهم إلى سماء المرح فيغني لهم في مناسبات زواجات أولادهم دون أن يتقاضى منهم أجرًا،
وفوق كل هذا يدفع لهم ما تيسر من ماله الحر، لتغطية نفقات زواجاتهم ويكلفه هذا السخاء المزدوج الاصطدام أحيانًا مع أحد أعضاء فرقته الموسيقية لكنه لا يكترث ولا يبالي بمن يحنق ويغضب عليه، ولا يعني ذلك التعدي على أجور أعضاء فرقته الموسيقية، بل يعوضهم ويضاعف لهم أجورهم حينما تتوافر مبالغ من السهرات السمينة، والإقرار بتعويضهم بشهادة من أعضاء الفرقة أنفسهم، والمؤلف عيدروس برهن على ذلك بالأسماء التي شهدت على هذا الفعل الناضح بالنبل.
إن بدوي المتقن في أداء الغناء والأقدر على تطريب وتنغيم القلوب، والمُنشد الباهر بصوته الصداح المليء بالجمال والجلال، سعى واجتهد إلى أن تتكامل شخصيته بالصدقات على المساكين والفقراء، وهذه مسألة ألح عليها القرآن في كثير من آياته. كان (أحمد) يحمد الله على ما أعطاه، ويستجيب لنداء كتابه بل ويتلذذ بالإنفاق المستمر، ولم يمثل الإنفاق عنده حالة عابرة، إذ ظل يعطي إلى آخر أيام حياته، لأنه يشعر بسعادة في العطاء، لأن في العطاء المنزه من أغراض المنفعة والمصلحة حالة من الجمال.
إن الشواهد والوقائع الدالة على فيض كرمه جمة إلى درجة أنها تدلت مثل (شماريخ النخيل) في كتاب ( عيدروس ) الجميل الذي رفع النقاب عن الوجه المنير لبدوي المتطلع للفوز برضى الله الرحمن الرحيم وبين انحيازه لقيم الروح وتلويحه بها في وجه قيم الجسد لتهدئة فورانها وإخماد نيرانها أن بدوى انتابه شعور عميق بضرورة الاستمرار في الانفاق إذ أصبحت هذه العملية بالنسبة له عبارة عن تمارين روحية تقوي عضلات التحدي لمواجهة قيم القبح والقباحة المتغلغلة في الواقع، ففضل التصدي لها بالوسائل الناعمة المنتمية إلى فردوس الجمال، ففيها عزف على نغم الصدقة ونغم الطرب والغناء الخالدين ، ولم يكتف بالعزف على هذا النغم، بل يُطّرز حواشيه بالزخرفة البديعة فله عادة حسنة يكررها كلما هل هلال العيد الأضحى أو عيد الفطر ففيهما يوزع اللحم على الفقراء ثم يطلب من شقيقه خميس أن يأتي بثياب عيده ليستبدلها بثيابه وهي أغلى في الثمن وأليق في المظهر وأحسن في لفت النظر فيلبسها وهو في غاية الفرح بها،
فهو يؤثر الغير على نفسه فيرغمها على قلع أشواك الأنانية الثاوية في دهاليزها التي أشد ما تكون رغبة في المباهاة والتفاخر بالملابس أمام الناس في عيدي الفطر والأضحى. وبدوي لا يشذ عن هذا النغم في الملابس فقط، بل وفي حب التخلي عن العقار فحينما سقط اسم من أسماء إخوته من كشف الأراضي تنازل عن اسمه ليحل شقيقه محله برضا تام وآثر شقيقه على نفسه، وهذه صورة من صور التغلب على آفات النفس التي يمكن كبح جماحها بالمجاهدة والصبر.
إن كل هذا البهاء في العطاء مكن بدوي من بناء مؤسسة خيرية تمشي على الأرض بناها بحجارة الروح والود الشفافة لا بحجارة الجبال الصلبة لا تراها جميع أبصار الناس. بل ذوو الخصوصية منهم أصحاب القلوب المؤتمنة الوفية المتناغمة مع الأعمال الإنسانية التي تعمل بصمت مثلما أراد لها بدوي الذي لا يحب أن يتظاهر بأعماله أمام الملأ، ومن كلفهم كانوا يحرصون على توصيل وتسليم أمانة الصدقات للفقراء واللافت للأمر أن هذه المؤسسة ليس لها اسم ولا عنوان ولا يافطة لا كبيرة ولا صغيرة تدل على مكانها من أجل الترويج والتصوير والدعاية لها، ولكن من تعامل معها وعرف خيرها لم يصعب عليه معرفة عنوانها، والمقال يرجح الفكرة التي تذهب إلى مثل هذه الأعمال الخيرية قد ألقت بظلالها الوارفة على شخصية بدوي فشحنتها بالرقة واللطف ، وكشفت في داخلها الوعي بالتسامح مع الآخر، وإن تسبب في أذاه وبالغ في الخصومة معه، ووصل في تسامحه إلى درجة عالية من التسامي ففي حادثة وفاة فلذة كبده ابنته عفى عن من تسبب في وفاتها قبل أن تدفن، ولم يكترث بمعاتبة أهله ، متمسكا برأيه الإيمان والاستسلام بقضاء الله وقدره، وهو في غاية اللطف والود مع أصحابه وأصدقائه، يبادر في المصالحة في حالة الخصومة معهم وإن تعنتوا، فتعنتهم لا يزيده إلا إصرارا على مصالحتهم، ولأنه فنان يعي قيمة تأثير الكلمات الشعرية في الوجد والوجدان وقدرتها على تذويب مشاعر الحنق والحماقة والغضب، فيلجأ إلى الشعر ويغنيه ، ليكون مدخلا دافئا للمصالحة مع من خاصموه من الذين يعملون في فرقته الموسيقية أو مع غيرهم، وفى بعض الأحيان يجعل من المداعبة جسرا ورديا للمصالحة، ففي أثناء تأديته للغناء على المسرح يشاهد من خاصمه مارا من بعيد فيطلق صوته بلهفة من يتوق للمصالحة بعد أن يُحرف بذكاء في كلمات الأغنية فيقول (كل يوم وأنت يا سالم تستلم مني جواب ) فيستبدل سالم بدلاً عن ظالم ، ثم بعد ذلك يردد (شفتك يا سالم شفتك) فيسري تأثير نبرته المعبرة على قلب من خاصمه وتأخذ المفاجأة حقها من التأثير أيضا فتسهم في تذويب ثلوج الخصومة وتنتهي. وكل هذه المعاملات بالكلمة الطيبة تُعدّ صورة من صور الصدقة، وبمناسبة ذكر تأثير الشعر على الوجد والوجدان، فإن بدوي لا يتعامل مع فن الشعر الغنائي معاملة من يتسلى به و يهز له أكتافه طربًا من دون ان يتأمله ويفقه معناه ، بل يتعامل معه معاملة من يستطعم حلاوته الروحية ويزيل به مرارة أحزانه، ويوقف نزيف لوعاته ويهدئ اشجانه و يعدل مزاجه، ويعود له صفاؤه، وبخاصة حينما ينشد أشعار الحبيب (علي بن محمد الحبشي) التي تشع عنوانات قصائده بأسرار العشق والعشاق للمعشوق الذي لا يقبل له شريك، والعاشق يبقى ويفنى في عشقه.نجد مثل هذه العنوانات المضيئة في قصائد مثل (أخشى على مهجتي ) ( واكتم هوانا إذا اردت رضانا ). و بدوي له فضل نقل بعض هذه الأناشيد من مجالها المحصور في السمع والاستماع إلى المجال الغنائي الطربي. إنه بمثل هذا النقل يعيد إنتاجها جماليا في إطار النغم والموسيقى لتأخذ حقها من الذيوع والانتشار. إن بدوي يتداوى بمثل هذه الأناشيد من أمراض الوجود التي لا يجد لها دواء عند الأطباء، وعبر عن هذا المضمون بلغة بسيطة لكنها دالة عندما رد على (علي بن يحيى المحضار) الذي استغرب منه في جلسة طرب في (جدة) حينما غنى ثلاث قصائد متتالية للحبشي فقال له (يا علي بحق الأخوة والصداقة إذا كان مزاجي ما هو رائق للطرب، و بغيت برجع للخط المعتاد لي في الطرب ما شي يردنا إلى ذلك إلا قصائد علي بن محمد الحبشي ) وإذا كان علي المحضار قد استغرب من بدوي اهتمامه الجم بالحبشي، فإن المقال لا يستغرب من تلك الأفكار الثمينة التي تفوه بها بدوي مثل قوله أنا أغني لنفسي، وأحيانا لفرد متفرد في ذوقه ومولع بالطرب، وأغنى من أجل ألا ينال الزمن ولو من بعض مما غنيته، وأن الشهرة لا تشترى بالمال، بل يصنعها الفنان الأصيل بدمه و سهره وجهده ، وغنى بدوى أغاني العوادي والدان وغيرها من الأغاني الثقيلة الدسمة بالجمال والدلال، فصار من السهل عليه أن يُغني الأغاني الشرحية فاشتهر وأصبح نجما في سماء الِكبار في حضرموت وخارجها، وارتبطت شهرته باسم بدوي زبير.